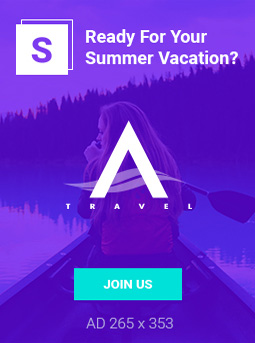مياه الوزاني: لبنان يهب العدو 300 مليون دولار سنوياً -- Aug 26 , 2025 168
بعد الدمار الواسع الذي لحق بالبنى التحتية في القرى الأمامية جنوب نهر الليطاني، ولا سيما في مدة الثمانين يوماً التي تلت الحرب الأخيرة، يعود ملف حقوق لبنان في مياه نهر الوزاني إلى الواجهة. وهذا الحق، وإن بدا بديهياً من حيث المبدأ، إلا أن تثبيته وحمايته يتطلبان جهداً استثنائياً وإرادة سياسية شجاعة من الدولة اللبنانية.
تاريخياً، تعود القضية إلى عام 1955 حين قدّم الموفد الأميركي إريك جونستون مشروعاً لتقاسم مياه نهر الأردن وروافده (الحاصباني، بانياس، اليرموك).
وفقاً للمشروع، كان مطلوباً من لبنان أن يكتفي باستخدام كمية محدودة من مياه الوزاني لا تُجاوز الـ35 مليون متر مكعب سنوياً، ضمن خطة توزيع تمنح إسرائيل الحصة الأكبر، يليها الأردن وسوريا، فيما تُترك للبنان الحصة الأقل. ورغم أن المشروع طُرح تحت شعار «تنمية إقليمية مشتركة»، إلا أن جوهره كان تكريس هيمنة إسرائيل على معظم موارد النهر، الأمر الذي دفع لبنان في النهاية إلى رفضه.
اليوم، تعود القضية نفسها بصيغ مختلفة، إذ برزت تصريحات متباينة لعدد من النواب اللبنانيين: بعضها يقدّر حصة لبنان بـ25 مليون متر مكعب، وأخرى ترفعها إلى 40 مليون متر مكعب. فيما المفارقة أن هذه الأرقام أقل بكثير مما رفضه لبنان قبل سبعين عاماً.
يبقى موضوع الحقوق في مصادر المياه من أكثر الملفات تعقيداً، إذ لا يوجد في القانون الدولي ما يُسمّى «الحق البديهي للدولة المشاطئة» في استخدام مياه الأنهار، بمعنى أن الأمر لا يُحتسب آلياً وفقاً لمعايير ثابتة ومعتمدة عالمياً. صحيح أن العوامل الجغرافية - مثل كمية المياه التي تنبع من أراضي الدولة، وطول مجرى النهر داخلها، وحجم الحوض المائي - تشكّل عناصر أساسية في تقدير الحقوق، إلا أنها ليست العوامل الحاسمة.
بحسب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وسيم ضاهر، فإن «حق الدول المشاطئة في استغلال مياه الأنهار العابرة للحدود يتحدد بما يضمن تلبية حاجاتها، مع احترام حقوق الدول الأخرى على قاعدة الحاجات ومبدأ حسن الجوار. أما العوامل الطبيعية والجغرافية، رغم أهميتها، فتبقى أساساً غير حاسم لتثبيت الحقوق ما لم تقترن بقوة تحميها».
ويضرب ضاهر مثالاً على ذلك من خلال النزاع حول تقاسم مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، إذ اختلف البلدان في كيفية احتساب حاجة مصر من المياه لتأمين أمنها الغذائي، فيما مضت إثيوبيا في بناء السدود من دون اتفاق مع باقي الدول المشاطئة، مستندةً تارةً إلى قوتها الذاتية، وتارةً أخرى إلى ضعف الآخرين في الدفاع عن حقوقهم. ويخلص إلى أن أي اتفاق حول المياه لا يُبنى على المعايير التقنية وحدها، بل يحتاج إلى عنصر القوة، إذ إن «اتفاقات المياه هي في جوهرها نتيجة مفاوضات أو حروب، يستخدم فيها كل طرف ما يمتلكه من أوراق قوة».
تبلغ مساحة حوض التجميع المائي لنهري الوزاني والحاصباني ما بين 600 و700 كلم² على السفوح الغربية لجبل الشيخ. وبحسب ضاهر، فإن الجريان المائي لا يقتصر على المياه السطحية الظاهرة (المقدّرة بنحو 135 مليون متر مكعب سنوياً)، بل يتعداها إلى جريان جوفي يفوق بكثير حجم الجريان السطحي.
ويتغذى نهر الأردن الأعلى من ثلاثة روافد رئيسية تلتقي شمالي بحيرة طبريا، وهي الحاصباني/ الوزاني الذي ينبع من جنوب لبنان ويمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويزوّد النهر، وفقاً للأرقام الرسمية، بنحو 135 مليون متر مكعب سنوياً. غير أن ضاهر يؤكد أن الكمية الحقيقية للمياه المتدفقة من لبنان، سطحياً وجوفياً، تقرب من 450 مليون متر مكعب سنوياً، وذلك عبر المياه الجوفية العابرة من لبنان والجارية سطحياً. كذلك يتغذّى نهر الأردن الأعلى من نهري بانياس وتل القاضي، ويشكّل هذان النهران مجتمعَين أكثر من 300 مليون متر مكعب سنوياً، رغم أن مساحة حوض تجميعهما لا تُجاوز الـ16 كلم² فقط. وفي هذا السياق، يسعى العدو الصهيوني إلى ضم مزارع شبعا، ليس فقط لأهميتها الإستراتيجية، بل أيضاً لإضافة نحو 300 كلم² إلى مساحة التجميع المائي، بما يزيد من حصته في معادلات المياه الإقليمية.
إذن، يقدّر مجموع المياه السطحية والجوفية التي تتدفق من لبنان نحو فلسطين المحتلة عبر الحاصباني/ الوزاني وروافده بنحو 400 إلى 450 مليون متر مكعب سنوياً. وبحسب ضاهر، إذا عدنا إلى اقتراح جونستون عام 1955، والذي خصّص للبنان 35 مليون متر مكعب سنوياً على أساس تقدير الكمية العابرة آنذاك بـ135 مليون متر مكعب، فإن الحساب نفسه اليوم - مع اعتبار الكمية العابرة نحو 450 مليون متر مكعب - يرفع حصة لبنان المفترضة إلى ما لا يقل عن 100 مليون متر مكعب سنوياً.
لكن الإشكالية، وفقاً لضاهر، لا تقتصر على الأرقام فقط، بل تتمثّل أيضاً في ثلاثة عوامل أساسية:
1- غياب مبدأ حسن الجوار، إذ لا يمكن للبنان أن يطبّق هذا المبدأ مع المغتصب الإسرائيلي.
2- معيار الحاجة المائية. إذ إن الحاجة الفعلية في الكيان غير المعترف به لبنانياً هي حاجة الفلسطينيين المقيمين في فلسطين المحتلة، والذين يقرب عددهم من 9 ملايين نسمة. أما الحسابات الإسرائيلية، فتشمل إلى جانب الفلسطينيين نحو 7 ملايين مستوطن، مضافاً إليهم ما تخطط تل أبيب لاستقدامه من يهود العالم. وتزداد الكميات المطلوبة بسبب الزراعة التصديرية الإسرائيلية، ولا سيما محاصيل الأفوكادو والفلفل والتمر التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
3- ما هي الحاجة الفعلية للكيان الإسرائيلي اليوم؟ وهل يُعقل أن يكون لبنان معنياً بتأمين مصالح عدوّه على حساب حقوقه ومصالح شعبه؟
انطلاقاً من النقطة الأخيرة، تبرز الحاجة إلى فهم طبيعة الحاجات المائية لدى الإسرائيليين اليوم. فمنذ التسعينيات، يعاني الكيان من أزمة مياه، ما دفعه إلى الاستثمار بكثافة في قطاع المياه وتطوير حلول بديلة. ونتيجة لذلك، أصبحت الشركات الإسرائيلية العاملة في مجالات تقنيات وحلول المياه تحتل مراكز متقدمة على المستوى العالمي. وفي هذا السياق، أنشأ الكيان منشآت متطورة لإعادة تكرير مياه الصرف الصحي، إلى جانب محطات تحلية ضخمة تؤمّن له أكثر من مليار متر مكعب من المياه سنوياً.
في هذه الحالة، يبرز سؤال أساسي يمكن للبنان أن يطرحه: ما هي حاجة الكيان الفعلية إلى المياه؟ هل تقتصر على الاستهلاك الداخلي للسكان، أم تشمل أيضاً الكميات الضخمة المستخدمة في الزراعة التصديرية؟ بمعنى آخر، هل يُطلب من لبنان أن يتخلى عن جزء من حقوقه المائية كي يتمكّن الإسرائيلي من تصدير منتجاته الزراعية إلى الخارج؟ وهل من المقبول أن يحرم لبنان نفسه من مياهه ليستطيع العدو أن يبيعها لاحقاً لدول أخرى، كما يفعل اليوم مع الأردن، حيث يبيع ما يقرب من 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً مقابل الحصول على 600 ميغاوات من الكهرباء عبر مشروع الطاقة الشمسية الممول من دول عربية؟
ويلفت ضاهر إلى أن الكيان يستفيد بشكل مباشر من المياه اللبنانية لسببين رئيسيين: أولاً، انخفاض ملوحتها مقارنةً ببحيرة طبريا، ما يسهم في تعديل ملوحة مياه البحيرة. وثانياً، انخفاض حرارتها نسبياً، وهو ما ينعكس إيجاباً على التوازن الحراري لمياه طبريا. ويكشف أن الإسرائيلي كان قد مدّ تمديدات من محطة أشدود للتحلية إلى بحيرة طبريا، تنقل نحو 100 مليون متر مكعب سنوياً. وهذه الخطوة «قد تشير، ربما، إلى أن الإسرائيلي كان يتوقّع أن يحصل لبنان على حصته الطبيعية البالغة 100 مليون متر مكعب سنوياً من المياه العابرة، وهو ما يفسّر سعيه المبكر إلى تعويض هذه الكمية عبر مشاريع التحلية».
ضاهر أشار إلى أن لبنان قدّم لسنوات «هبة مائية» للاحتلال الإسرائيلي تُجاوز قيمتها الـ300 مليون دولار سنوياً، عبر تصريف المياه العابرة لحدوده. إذ إن كلفة تحلية المياه على الساحل في الكيان كانت تُجاوز دولاراً للمتر المكعب في السابق، وانخفضت حالياً إلى 0.52 دولار بعد استخدام الغاز المحلي في عمليات التحلية. وأوضج أن الفائدة الاقتصادية السنوية للمياه العابرة من لبنان إلى فلسطين المحتلة «تتجاوز 300 مليون دولار، إذا احتسبنا تكلفة الضخ التي يوفرها العدو بسبب ارتفاع نهر الوزاني (حوالى 300 متر) عن سطح البحر، إضافة إلى العائد الاقتصادي من المياه المستخدمة في الزراعة والصناعة والسياحة»، مشدداً على أن «لبنان يجب أن يستفيد من 100 مليون متر مكعب سنوياً على الأقل من هذه المياه العابرة جنوباً قبل أي مفاوضات، علماً أن هذه المياه ضرورية لتأمين حاجيات قرى بنت جبيل ومرجعيون وأعالي صور، التي ستبقى عطشى لولاها بسبب افتقارها إلى مصادر بديلة».
في ظل التراخي الواضح للدولة اللبنانية تجاه حقوق مواطنيها المائية في مواجهة الاحتلال والكيان الصهيوني، يبرز سؤال جوهري: ماذا ستفعل الدولة لحفظ حقوق لبنان في مياه نهر الوزاني؟ علماً أن لبنان يستهلك حالياً نحو 3 إلى 6 ملايين متر مكعب سنوياً من مياه الوزاني/ الحاصباني، وهذا الرقم يُعد كارثياً وضعيفاً جداً مقارنة بحق لبنان الكامل في المياه العابرة من أراضيه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الاخبار